منزلة الصبر
فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعا
الأول: الأمر به نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ} [ البقره: 153 ] وقوله: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ} [ البقره: 45 ] وقوله: { اصْبِرُوا وَصَابِرُوا} [ آل عمران: 20 ] وقوله: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [ النحل: 127 ]
الثاني: النهي عن ضده كقوله: { فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ} [ الأحقاف: 35 ] وقوله: {فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [ الأنفال: 15 ] فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة وقوله: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } 0 [ محمد: 33 ] فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها وقوله: فلا تهنوا ولا تحزنوا [ آل عمران: 139 ] فإن الوهن من عدم الصبر
الثالث: الثناء على أهله كقوله تعالى: {الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ} الآية [ آل عمران: 17 ] وقوله : { وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [ البقره: 177 ] وهو كثير في القرآن
الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم كقوله: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} [ آل عمران: 146 ]
الخامس: إيجاب معيته لهم وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليست معية عامة وهي معية العلم والإحاطة كقوله: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [ الأنفال: 46 ] وقوله: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [ البقره: 249 الأنفال: 69 ]
السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله: {وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [ النحل: 126 ] وقوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [ النساء: 25 ]
السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم كقوله تعالى: {وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [ النحل: 96 ]
الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب كقوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [ الزمر: 10 ]
التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر كقوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [ البقره: 155 ]
العاشر: ضمان النصر والمدد لهم كقوله تعالى : بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ} [ آل عمران: 125 ] ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر
الحادى عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [ الشورى: 43 ]
الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر كقوله تعالى: {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} [ القصص: 80 ] وقوله: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [ فصلت: 35 ]
الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر كقوله تعالى لموسى: {أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [ إبراهيم: 5 ] وقوله في أهل سبأ: {فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [ سبأ: 19 ] وقوله في سورة الشورى: { وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [ الشورى: 3233 ]
الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر كقوله تعالى: {وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [ الرعد: 2324 ]
الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ} [ السجده: 24 ]
السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنه ضياء وقال: من يتصبر يصبره الله وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن ! إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته: أن يدعو لها: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: إني أتكشف فادع الله: أن لا أتكشف فدعا لها وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر وأمر بالصبر عند المصيبة وأخبر: أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى
وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره والجزع والتسخط والتشكى يزيد في المصيبة ويذهب الأجر وأخبر أن الصبر خير كله فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع: من الصبر
فصل و الصبر في اللغة: الحبس والكف ومنه: قتل فلان صبرا
إذا أمسك وحبس ومنه قوله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [ الكهف: 28 ] أي احبس نفسك معهم
فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على امتحان الله فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته إن لم يفعل: بالسجن والصغار ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه
وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة: أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية وله رحمه الله فى ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاليس هذا موضع ذكرها والمقصود: الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته والله الموفق
فصل وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله
فالأول: أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما قال تعالى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [ النحل: 127 ] يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها يتوجه معها أين توجهت ركائبها وينزل معها أين استقلت مضاربها فهذا معنى كونه صابرا مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن وهجران الخلق في جنب الله شديد والمسير من النفس إلى الله صعب شديد والصبر مع الله أشد وسئل عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبس
قال ذو النون المصري الصبر التباعد من المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة
وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل: هو الفناء في البلوى بلا ظهور ولا شكوى وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين واعجبا ! كيف يصبرون وأنشد:
الصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل
وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله وقيل: هو ترك الشكوى وقيل:
الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل
وقيل: الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه كما قيل:
سأصبر كي ترضى وأتلف حسرة وحسبي أن ترضي ويتلفني صبري
وقيل: مراتب الصابرين خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار فالصابر: أعمها والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره والصبار: الكثير الصبر فهذا فى القدر والكم والذي قبله في الوصف والكيف وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو
وقف رجل على الشبلي فقال: أي صبر أشد على الصابرين فقال: الصبر في الله قال السائل: لا فقال: الصبر لله فقال: لا فقال: الصبر مع الله فقال: لا قال الشبلي: فإيش هو قال: الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف وقال الجريري: الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة وحال المحبة مع سكون الخاطر فيهما والتصبر: هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال أثقال المحنة قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته فإن الله مع الصابرين وقيل في قوله تعالى: {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} [ آل عمران: 200 ] إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى ف الصبر دون المصابرة و المصابرة دون المرابطة و المرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد وسمى المرابط مرابطا: لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وقال رباط يوم فى سبيل الله: خير من الدنيا وما فيها وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوي في الله ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله وقيل: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء فالصبر مع نفسك و المصابرة بينك وبين عدوك و المرابطة الثبات وإعداد العدة وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعثه وقيل: تجرع الصبر فإن قتلك قتلك شهيدا وإن أحياك أحياك عزيزا وقيل: الصبر لله غناء وبالله تعالى بقاء وفي الله بلاء ومع الله وفاء وعن الله جفاء والصبر على الطلب عنوان الظفر وفي المحن عنوان الفرج
وقيل: حال العبد مع الله رباطه وما دون الله أعداؤه وفي كتاب الأدب للبخارى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الصبر والسماحة ذكره عن موسى بن اسماعيل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده فذكره وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه: السماحة وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه: الصبر
وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه و الصفح الجميل هو الذى لا عتاب معه و الهجر الجميل هو الذي لا أذى معه وفي أثر اسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: أنزلت بعبدى بلائي فدعاني فما طلته بالإجابة فشكاني فقلت: عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك وقال ابن عيينة في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا} [ السجدة: 24 ] قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء وقيل: صبر العابدين أحسنه: أن يكون محفوظا وصبر المحبين أحسنه: أن يكون مرفوضا كما قيل:
تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب
والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل والنبي إذا وعد لا يخلف ثم قال: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [ يوسف: 86 ] وكذلك أيوب أخبر الله عنه: أنه وجده صابرا مع قوله: { مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [ الأنبياء: 83 ]
وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك ثم أنشد :
وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم
فصل قال صاحب المنازل: الصبر: حبس النفس على المكروه وعقل اللسان
عن الشكوى وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد
وإنما كان صعبا على العامة: لأن العامي مبتدىء في الطريق وما له دربة في السلوك ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لأنه ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضى محبوبه
وأما كونه وحشة في طريق المحبة: فلأنها تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له والصبر يقتضي كراهيته لذلك وحبس نفسه عليه كرها فهو وحشة في طريق المحبة وفي الوحشة نكتة لطيفة لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب بالمحبوب فإذا أحس بالألم بحيث يحتاج إلى الصبر انتقل من الأنس إلى الوحشية ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد: لأن فيه قوة الدعوى لأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة وهذا مصادمة لتجريد التوحيد إذ ليس لأحد قوة ألبتة بل لله القوة جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهذا سبب كون الصبر منكرا في طريق التوحيد بل من أنكر المنكر كما قال لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله والصبر يرد الأشياء إلى النفس وإثبات النفس في التوحيد منكر هذا حاصل كلامه محررا مقررا وهو من منكر كلامه بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها وحاجة المحب إليه ضرورية فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب
قيل: هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها وصادقها من كاذبها فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة ولم يثبت معه إلا الصابرون فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر: لما ثبتت صحة محبتهم وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه فقال عن حبيبه أيوب:
{إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً} [ ص: 44 ] ثم أثنى عليه فقال: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ ص: 44 ] وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره به وأثنى على الصابرين أحسن الثناء وضمن لهم أعظم الجزاء وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم فجعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوى وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبر وأخبر أن الصبر خير لأهله وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقدم ذلك
وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبعي لها كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألمها بفقده فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية وإلا لم تكن نفسا إنسانية ولارتفعت المحنة وكانت عالما آخر
و الصبر و المحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان والمحب صبور بل علة الصبر فى الحقيقة: المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضى المحبوب بل إرادة غيره أو مزاحمته بإرادة غيره أو المراد منه لا مراده هذه هي وحشة الصبر ونكارته وأما من رأى صبره بالله وصبره لله وصبر مع الله مشاهدا أن صبره به تعالى لا بنفسه فهذا لا تلحق محبته وحشة ولا توحيده نكارة ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبر وهو الصبر على المكاره فأما الصبر على الطاعات وهو حبس النفس عليها وعن المخالفات وهو منع النفس منها طوعا واختيارا والتذاذا فأي وحشة في هذا وأي نكارة فيه فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبة ورضى وإيثارا: لم يكن الحامل له على ذلك الصبر فيكون صبره في هذا الحال ملزوم الوحشة والنكارة لمنافاتها لحال المحب قيل: لا منافاة في ذلك بوجه فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه وصار الحكم للرضى لا أن الصبر عدم بل لقوة وارد الرضى والحب وإيثار مراد المحبوب صار المشهد والمنزل للرضى بحكم الحال والصبر جزء منه ومنطو فيه ونحن لا ننكر هذا القدر فإن كان هو المراد فحبذا الوفاق وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال وإن كان غيره: فقد عرف ما فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل قال: وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية
بمطالعة الوعيد: إبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام وأحسن منها: الصبر عن المعصية حياء ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين
أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها والثاني: الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم وأما الفائدتان: فالابقاء على الإيمان والحذر من الحرام فأما مطالعة الوعيد والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب فيترك معصيته محبة له كحال الصهيبيين وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان: يبعث على ترك المعصية لأنها لا بد أن تنقصه أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته أو تطفىء نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان يعلم بالوجود والخبر والعقل كما صح عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد وأما الحذر عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح حذرا من أن يسوقه إلى الحرام ولما كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية: كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف
فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها قال: الدرجة الثانية: الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما هذا يدل على أن عنده: أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة وهذا هو الصواب كما تقدم فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة والنهي مقصود للأمر فالمنهي عنه لما كان يضعف المأموز به وينقصه: نهي عنه حماية وصيانة لجانب الأمر فجانب الأمر أقوى وآكد وهو بمنزلة الصحة والحياة والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة وذكر الشيخ: أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دوام الطاعة والإخلاص فيها ووقوعها في مقتضى العلم وهو تحسينها علما فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة فإن العبد إن لم يحافظ عليها دواما عطلها وإن حافظ عليها دواما عرض لها آفتان:
إحداهما: ترك الإخلاص فيها بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته والتقرب إليه فحفظها من هذه الآفة: برعاية الإخلاص
الثانية: ألا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة فحفظها من هذه الآفة: بتجريد المتابعة كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة فلذلك قال: بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما
فصل قال: الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء إحداها: ملاحظة حسن الجزاء وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة فالنفس موكلة بحب العاجل وإنما خاصة العقل: تلمح العواقب ومطالعة الغايات وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من رافق الراحة فارق الراحة وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة فإن قدر التعب تكون الراحة
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم الكرائم
ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم
والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك والثاني: انتظار روح الفرج يعني راحته ونسيمه ولذته فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته: ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف والثالث: تهوين البلية بأمرين أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر الثاني: تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه فهذا يتعلق بالماضي وتعداد أيادي المنن: يتعلق بالحال وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج: يتعلق بالمستقبل وأحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء
ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت فانقطعت إصبعها فضحكت فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك فقالت: أخاطبك على قدر عقلك حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام من ملاحظة المبتلي ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء
وتلذذها بالشكر له والرضى عنه ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر كما قيل:
لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالكا
فصل قال: وأضعف الصبر: الصبر لله وهو صبر العامة وفوقه:
الصبر بالله وهو صبر المريدين وفوقه: الصبر على الله وهو صبر السالكين معنى كلامه: أن صبر العامة لله أي رجاء ثوابه وخوف عقابه وصبر المريدين: بالله أي بقوة الله ومعونته فهم لا يرون لأنفسهم صبرا ولا قوة لهم عليه بل حالهم التحقق ب لا حول ولا قوة إلا بالله علما ومعرفة وحالا
وفوقهما: الصبر على الله أي على أحكامه إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه فهو يصبر على أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه فهذه درجة صبر السالكين وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام إذ هو في مقام الصبر وقد ذكر: أنه للعامة وأنه من أضعف منازلهم هذا تقرير كلامه
والصواب: أن الصبر لله فوق الصبر بالله وأعلى درجة منه وأجل فإن الصبر لله متعلق بإلهيته والصبر به: متعلق بربوبيته وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته ولأن الصبر له: عبادة والصبر به استعانة والعبادة غاية والاستعانة وسيلة والغاية مرادة لنفسها والوسيلة مرادة لغيرها ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به وأما الصبر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين وأصحاب مشهد إياك نعبد وإياك نستعين
ولأن الصبر له: صبر فيما هو حق له محبوب له مرضى له والصبر به: قد يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له وقد يكون في مكروه أو مباح فأين هذا من هذا وأما تسمية الصبر على أحكامه صبرا عليه فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى فهذا هو الصبر على أقداره وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة وقد عرفت بما تقدم: أن الصبر على طاعته والصبر عن معصيته: أكمل من الصبر على أقداره كما ذكرنا في صبر يوسف عليه السلام فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة والصبر على أحكامه الكونية: صبر ضرورة وبينهما من البون ما قد عرفت وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن قلت: الصبر بالله أقوى من الصبر لله فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته وما كان به لم يقاومه شيء ولم يقم له شيء وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير والصبر لله صبر أهل العبادة والزهد ولهذا هم مع إخلاصهم وزهدهم وصبرهم لله أضعف من الصابرين به فلهذا قال: وأضعف الصبر: الصبر لله قيل: المراتب أربعة
إحداها: مرتبة الكمال وهي مرتبة أولي العزائم وهي الصبر لله وبالله
فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به متبرئا من حوله وقوته فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها
الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا فهو أخس المراتب وأردأ الخلق وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان
الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حوله وقوته متبرىء من حوله هو وقوته ولكن صبره ليس لله إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له وربما كانت عاقبته شر العواقب وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم وهم من جنس الملوك الظلمة فإن الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر
الرابع: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه فهذا له عاقبة حميدة ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين فنصيبه من الله: أقوى من نصيبه بالله فهذا حال المؤمن الضعيف وصابر بالله لا لله: حال الفاجر القوي وصابر لله وبالله: حال المؤمن القوي والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
فصابر لله وبالله عزيز حميد ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول ومن هو بالله لا لله قادر مذموم ومن هو لله لا بالله عاجز محمود
فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب ويتبين فيه الخطأ من الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم
تقلب المؤمن بين الشكر والصبر
دَيدنُ المؤمن الحقّ وسِمَته التي يمتاز بها ونهجُه الذي لا يحيدُ عنه شكرٌ على النّعماء وصَبر على الضراء، فلا بَطَرَ مع النعَم، ولا ضَجر مع البلاء، ولِمَ لايكون كذلك وهو يتلو كتابَ ربه الأعلى وفيه قوله
سبحانه: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}[إبراهيم: 7]،
وفيه قولُه عزّ اسمه: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر:10]، وقولُه سبحانه: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:46]،
إلى غير ذلك من الآياتِ الكثيرة الدالّة على هذا المعنى.
وبيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميلَ حال المؤمن في مقامِ الشكر والصبر وكريمَمآله، فقال: (عجبًا لأمرِ المؤمن، إنّ أمره كلَّه خير، وليس ذلك لأحدٍ إِلَّا للمؤمن، إن أصابَته سرّاء فشكر فكان
خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء
صبر فكان خيرًا له)[1] فالعَبد ما دام في دائرة التكليف؛ فمِناهج الخير مُشرَعَةٌ بَين يديه، فإنّه متقلّبٌ بين نِعمةٍ وَجب شُكرُها، ومُصيبة وجَب الصبرعليه، وذلك لازمٌ له في كلِّ أشواط الحياة.
ولقد كان للسَّلف -رضوان الله عليهم- أوفَرُ الحظّ وأروع الأمثال في الشّكر والصبر،ممَّا جعل منهم نماذجَ يُقتَدَى بها ومناراتٍ يُستَضاء بها وغاياتٍ يُنتهَى إليهافي هذا البابِ، حيث كان لهم في صدرِ الإسلام
وقفاتٌ أمام صولةِ الباطل
وما نالهم منه من أذى ونكال وما صبَّ عليهم هذا الباطل من عَذاب، فلم يزِدهم الأذى والنّكالوالعذاب إِلَّا صبرًا وثباتًا على الحقّ وصمودًا وإصرارًا على مقارعةِ المبطلين.
ثم خلف من بعدهم خلفٌ فَتّ في عضدهم صروفُ الدهر ونوائب الأيام، ونالت من عزائِمهموحادَت بهم عن الجادّة مضلاَّت الفِتن، فإذا هم لا يُعرَفون بشكر إزاءَ نِعمة، ولابصبرٍ أمام محنةٍ، فهم داخلون فيمن
وصف سبحانه واقعَه
بقوله: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الحج: 11].
فترى منهم الذي يجوِّز على الله الظلمَ في حكمه ويتَّهمه في عدلِه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا، لا حديثَ له في غير الاعتراض على ربِّه أن أغنى فلانًا أو أفقرَ فلانًا أو رفَع هذا ووضَع ذاك، وربما قال:
لِمَ هذا يا ربّ؟! وكأنّه
يتغافل أو يغفل عن قوله سبحانه: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}
[الزخرف: 32]،
وعن قوله عزَّ من قائل: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23].
فاتّقوا الله عبادَ الله، واقطعوا أشواطَ الحياة بإيمان راسخٍ ويقين ثابتٍ وتوكّلعلى ربّكم الأعلى وتسليمٍ له وإنابةٍ إليه وتصدِيق بأن كلّ قضاءٍ يقضي الله به ففيهالخير لعبده عاجلاً كان ذلك أم آجلًا، فإنّه سبحانه
أرحم بعبادِه من الأمّ
بولدها،وأعلَمُ بما ينفعُهم على الحقيقةِ ممّا يضرُّهم، {وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216].
واذكروا أنَّ من آياتِ الإيمان الصبرَ على البلاء والشكرَ على النعماء، وصدَق سبحانه إذ يقول: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
[التغابن:11].
للشيخ أسامة الخياط
[1] أخرجه مسلم في صحيحه.
*********
الحج المبرور
الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر العظام تهفوا إليه الأفئدة وتحنو إليه القلوب، وتتوق في أشهره النفوس إلى زياره تلك البقاع الطاهرة تحقيقا لقول الله عز وجل:
“وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا”، وقوله:”وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ”.
يتدافع الحجاج كل عام يحدوهم الشوق إلى تلك البقاع الطاهرة وكلهم أمل في أن يرجعوا من ذنوبهم كاليوم الذي خرجوا فيه من بطزن أمهاتهم ؛ “فالحج يهدم ما كان قبله” كما في صحيح مسلم ، ومن حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه” كما في صحيح البخاري، و”الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب ” كما في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة.
ومن لم يوفق للحج ولم يستطع السير إليه فإنه يودع الحجيج ويتابع مناسكهم ولسان حاله:
يا سائرين إلى البيت العتيق لقد … سرتم جسوما و سرنا نحن أرواحا
إنا أقمنا على عذر و قد رحلوا … و من أقام على عذر كمن راحا
لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم ألا وهو الحرص على أن يكون حجنا مبرورا ؛ فمغفرة الذنوب بالحج و دخول الجنة به مرتب على كون الحج مبرورا .
وقد أشارت الأحاديث إلى ذلك ، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : سُئِل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ” أيُّ العمل أفْضَل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهادُ في سبيل الله ، قيل: ثم ماذا ؟ قال:حَجّ مبرور “.
وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة – رضي الله عنه -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”
فما هو الحج المبرور:
قال أهل العلم يكون الحج مبرورا باجتماع عدة أمور منها:
1- إيفاء أركانه وواجباته، أي: الإتيان به على الوجه الأكمل ، فقد بين النبي صلى الله مناسك الحج للأمة قوليا وعمليا في حجة الوداع وقال هناك (خُذُوا عَني مَناسِكَكُمْ ، لا أدري لَعَلَّي لا أَحُجُّ بعد حَجَّتي هذه) أخرجه مسلم.
2- ومنها الإتيان فيه بأعمال البر: أي فعل الطاعات كلها و قد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله :
” و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ “البقرة177
فتضمنت الآية –كما يقول الإمام ابن رجب في لطائف المعارف-: أن أنواع البر ستة أنواع من استكملها فقد استكمل البر : أولها : الإيمان بأصول الإيمان الخمسة و ثانيها : إيتاء المال المحبوب لذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب و ثالثها : إقام الصلاة و رابعها : إيتاء الزكاة و خامسها : الوفاء بالعهد و سادسها : الصبر على البأساء و الضراء و حين البأس و كلها يحتاج الحاج إليها ،فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان و لا يكمل حجه و يكون مبرورا بدون إقام الصلاة و إيتاء الزكاة فإن أركان الإسلام بعضها مرتبطة ببعض فلا يكمل الإيمان و الإسلام حتى يؤتي بها كلها و لا يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات و المشاركات المحتاج إليها في سفر الحج و إيتاء المال المحبوب لمن يحب الله إيتاءه و يحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من المشاق في السفر فهذه خصال البر .
3- ومنها حسن معاملة الناس والتحلي بحسن الخلق : فالإحسان إلى الناس من البر كما يقال البر والصلة ، و في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن البر ؟ فقال : ” البر حسن الخلق ” و كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إن البر شيء هين : وجه طليق و كلام لين.
و هذا يحتاج إليه في الحج كثيرا أي معاملة الناس بالإحسان بالقول و الفعل-كما يقول الإمام ابن رجب- قال بعضهم : إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ، وفي المسند والمستدرك عن جابر رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بر الحج ؟ قال:إطعام الطعام و إفشاء السلام وفي لفظ(و طيب الكلام) ضعفه ابن حجر وحسنه الألباني.
و من أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه و سلم أبا جري جابر بن سليم الهجيمي حيث قال : ” لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشئ من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الارض وإن سبك رجل بشئ يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه. ” أخرجه الحاكم.
وفي رواية”و إن امرؤ شتمك و عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه ، فإنما وبال ذلك عليه و لا تسبن أحدا قال : فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة ” .وفي الحديث قصة وهي مروية عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائى ، ، والطبرانى ، وابن حبان ، والبيهقى فى شعب الإيمان وغيرهم وصححه الألباني. .
و في الجملة : فخير الناس أنفعهم للناس و أصبرهم على أذى الناس كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى : “الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين”
و الحاج يحتاج إلى مخالطة الناس،و المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم و لا يصبر على أذاهم .
4- ومنها كثرة ذكر الله تعالى فيه و قد أمر الله تعالى بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى كما قال سبحانه : “لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ” البقرة .
و خصوصا كثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية و التكبير ، ففي سنن الترمذي وابن ماجه و غيرهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ” أفضل الحج العج و الثج ” والعج: هو رفع الصوت بالتكبير والتلبية ، والثج: هو إراقة دماء الهدايا و النسك .
5- ومنها اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث و الفسوق و المعاصي ، قال الله تعالى : ” الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ” البقرة 197.
و في الحديث الصحيح: “من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ” رواه البخاري ومسلم.
فما تزود حاج و لا غيره بأفضل من زاد التقوى و لا دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى .
وقد روى الترمذي وقال : حديث حسن ،
عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – : قال : ” جاء رجلٌ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال : إِني أُرِيدُ السفر ، فزَوِّدني ، قال : زَوَّدك اللهُ التَّقوى ، قال : زِدني ، قال : وغفر ذَنبَكَ ، قال : زدني، – بأبي أنتَ وأُمِّي – قال : ويَسَّرَ لك الخير حيثما كنتَ”.
وقال بعض السلف: لمن ودعه للحج أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه و سلم معاذا حين ودعه : ” اتق الله حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن”
6- ومنها أن يطيب نفقته في الحج وأن لا يجعلها من كسب حرام، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وقد قيل:
إذا حججت بمال أصله سحت … فما حججت و لكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل صالحة … ما كل من حج بيت الله مبرور
7- ومنها أن لا يقصد بحجه رياء و لا سمعة و لا مباهاة و لا فخرا و لا خيلاء و لا يقصد به إلا وجه الله و رضوانه و يتواضع في حجه و يستكين و يخشع لربه.
إذلايُقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله ، فقدقال الله تعالى”وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ”. وروى أبو داود والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ” إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه”
روي ابن ماجة والتِّرْمِذِيّ في (الشَّمائل) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم حج على رحل رث و قطيفة ما تساوي أربعة دراهم و قال : اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها و لا سمعة .
أتاك الوافدون إليك شعثا … يسوقون المقلدة الصواف
فكم من قاصد للرب رغبا … و رهبا بين منتعل و حاف
8- وقيل ( المبرور ) : المقبول. قالوا : ومن علامات قبول الحج، أن يرجع العبد خيرًا مما كان، ولا يعاود المعاصي.
وعلى كل فكما قال الإمام الْقُرْطُبِيّ : الْأَقْوَال الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيره مُتَقَارِبَة الْمَعْنَى ، وَهِيَ أَنَّهُ الْحَجّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامه وَوَقَعَ مَوْافقا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّف عَلَى الْوَجْه الْأَكْمَل. نقله ابن حجر في (فتح الباري) وَاَللَّه تعالى أَعْلَم .
أسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبدالمحمود يوسف عبدالله

**********
البركة في عشر ذي الحجة
لقد كتب الله على نفسه الرحمة، ونشر رحمته بين العباد، وجعلها واسعة بفضله حتى وسعت كل شيء، يقول سبحانه: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الأعراف:156، ومن رحمتة جل وعلا بنا أن جعل لنا مواسم ونفحات تُضاعف فيها الحسنات وتزداد فيها الدرجات ويستدرك العبد بها ما فات ، فالسعيد من تنبه لها واستفاد منها والشقي من غفل عنها وضيع نفسه.
ومن هذه المواسم المباركة أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا ،فأيامها أفضل من أيام رمضان وليلي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة .
دلائل فضل هذه الأيام
أولاً: إن الله أقسم بها ولا يقسم ربنا إلا بعظيم من المخلوقات أو الأوقات،قال تعالى: ( وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) الفجر:2
وهي عشر ذي الحجة كما قال أهل التفسير.
ثانياً: صح فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء».
أخرجه البخاري ومسلم
وفي حديث أخر يقول صلى الله عليه وسلم : «ما من عمل أزكي عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى، قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء» صحيح الترغيب والترهيب 1148.
ثالثاً: من فضائلها أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات كما في غيرها، وفيها الصدقة لمن حال عليه الحول فيها، وفيها الصوم لمن أراد التطوع، أو لم يجد الهدي، وفيها الحج إلى البيت الحرام ولا يكون في غيرها، وفيها الذكر والتلبية والدعاء الذي تدل على التوحيد، واجتماع العبادات فيها شرف لها لا يضاهيها فيه غيرها ولا يساويها سواها.
رابعاً : فيها يوم عرفة ،وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وهو يوم مغفرة الذنوب، والتجاوز عنها، والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة».
وروى ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ» وفي رواية: «إنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ مَلَائِكَتَهُ, فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي, اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي, قَدْ أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ».
خامساً: ومن فضائلها: أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام كما في الحديث: «أفضل الأيام يوم النحر» [رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح].، وفي يوم النحر معظم أعمال النسك للحجاج من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية.
السلف والعشر
كان سلفنا الصالح يعظمون هذه الأيام ويقدرونها حق قدرها، قال أبو عثمان النهدي كما في لطائف المعارف: “كان السلف ـ يعظّمون ثلاثَ عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم». وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم»، يعني في الفضل، وروي عن الأوزاعي قال: «بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها، إلا أن يختص امرؤ بالشهادة».
يا له من موسم يفتح للمتنافسين ويا له من غبن يحق بالقاعدين والمعرضين فاستبقوا الخيرات يا عباد الله وسارعوا إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض وإياكم والتواني وحذار من الدعة والكسل .
يستحب في هذه الأيام
1- الحج:
من أجلِّ الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه العشر أداء مناسك الحج الذي أوجبه الله تعالى على كل مسلم قادر تحققت فيه شروط وجوبه،قال صلى الله عليه وسلم : «من حجَّ هذا البيتَ فلم يرفث ولم يفسُق رجع من ذنوبه كيوم ولدَته أمُّه» متفق عليه ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «تابِعوا بين الحجِّ والعمرة؛ فإنّهما ينفيان الفقر والذنوبَ كما ينفي الكير خَبثَ الحديدِ والذّهب والفضَّة، وليس للحجّة المبرورةِ ثوابٌ إلاّ الجنّة» رواه الترمذيّ والنسائي وسنده صحيح.
2- الصيام :
يستحب الإكثار من الصيام في أيام العشر، ولو صام التسعة الأيام لكان ذلك مشروعاً، لأن الصيام من العمل الصالح، قال صلى الله عليه وسلم : «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا»أخرجه البخاري ومسلم.
ويزداد أجر الصيام إذا وقع في هذه الأيام المباركة، قال النوويّ رحمه الله: «فليس في صومِ هذه التسعة ـ يعني تسع ذي الحجّة ـ كراهةٌ شديدة، بل هي مستحبّة استحبابًا شديدًا» شرح صحيح مسلم 8/71
.وصوم يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين قال صلى الله عليه وسلم :«صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسـنة التي بعده…»
أخرجـه مسلم في: الصيام 1162
والمراد بها الصغائر، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء, وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر، يُرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رُفعت درجات شرح مسلم 8/50/ 5
3- القران :
القرآن التجارة التي لن تبور ،حاول أن تختمه في هذه العشر ،قال صلى الله عليه وسلم : «لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم ،
واعلم أخي المسلم انك لن تتقرب إلى الله بمثل كتابه تلاوةً وتدبراً وتحكيماً.
4- الصلاة:
قال صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر»
صحيح الجامع 3870 ،
وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : «ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن». صحيح الجامع 3518.
ولا تنس أخي بناء بيت في الجنة بصلاة اثنتا عشرة ركعة تطوع من غير الفريضة ، وصلاة الضحى ركعتان أو أكثر، و قيام الليل ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ذكر منهم الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن يقوم من الليل فيقول الله: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد» الطبراني بإسناد حسن
المحافظة على النوافل سبب من أسباب محبة الله، ومن نال محبة الله حفظه وأجاب دعاءه، وأعاذه ورفع مقامه، لأنها تكمل النقص وتجبر الكسر وتسد الخلل.
5- الذكر:
الذكر هو أحب الكلام إلى الله تعالى، وهو سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وهو سبب الفلاح، به يُذكر العبد عند الله، ويصلي الله وملائكته على الذاكر، وهو أقوى سلاح، وهو خير الأعمال وأزكاها وأرفعها في الدرجات، وخير من النفقة، به يضاعف الله الأجر، ويغفر الوزر، ويثقل الميزان، يقول تعالى:( لّيَشْهَدُواْ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ ٱلاْنْعَامِ) الحج:28،
روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»، وكان أبو هريرة وابن عمر ب إذا دخلت عشر ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران فيكبِّر الناسُ بتكبيرهما. رواه البخاري
والتكبيرُ عند أهلِ العلم مطلقٌ ومقيّد، فالمطلق يكونُ في جميع الأوقات في الليل والنهار من مدّة العشر، والمقيّد هو الذي يكون في أدبارِ الصّلواتِ فرضِها ونفلِها على الصّحيح، للرّجال والنّساء.
وأصحُّ ما ورد في وصفِه ـ أي: التكبير المقيّد ـ ما ورَد مِن قولِ عليّ وابن عبّاس ن أنّه مِن صُبح يومِ عرفة إلى العصرِ من آخر أيّام التشريق (الثالث عشر )وأمّا للحاجّ فيبدأ التكبيرُ المقيّد عقِب صلاةِ الظهر من يوم النحر. وصحّ عن عمر وابن مسعود ب صيغة: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
6- الصدقة:
الصدقة، وإغاثة الملهوف، وإطعام الجائع، وتفريح المؤمن وإدخال السرور على نفسه وطرد الهم عنه مما يحبه الله تعالى، فبالصدقة ينال الإنسان البر ويضاعف له الأجر ويظله الله في ظله يوم القيامة، ويُفتح بها أبواب الخير ويغلق بها أبواب الشر، ويفتح فيها باب من أبواب الجنة، ويحبه الله ويحبه الخلق، ويكون بها رحيماً رفيقاً، ويزكي ماله ونفسه، ويغفر ذنبه، ويتحرر من عبودية الدرهم والدينار، ويحفظه الله في نفسه وماله وولده ودنياه وآخرته.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله أي الأعمال أحب إلى الله فقال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عن كربه أو تقضى عنه ديناً أو أتطرد عنه جوعاً» رواه الطبراني وصححه الألباني
7- الأضحية:
شُرعت الأضاحِيَّ تقرُّبًا إلَى اللهِ بدمائِهَا، وتصدقًاً علَى الفقراءِ بلحمِهَا، والأضحيةُ مِنْ شعائرِ الإسلامِ، وهِيَ رمزٌ للتضحيةِ والفداءِ، وسنةُ أبِي الأنبياءِ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم، وهِيَ أحبُّ الأعمالِ إلَى اللهِ فِي يومِ العيدِ، فعَنِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ إلى أَحَبَّ اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْساًِ» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ،
و الأضحية سنة مؤكدة يُكره للقادر تركها.
ومن أحكام الأضحية أن تبلغ السن المجزئة شرعاً، فمن الغنم ما أتم سنة كاملة، ومن الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين كاملتين، وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص، فلو اشترك سبعة في بعير أو بقرة أجزأت عنهم جميعًا.
وللأضحية شروط لا بد من توفرها، منها السلامة من العيوب التي وردت في السنة، وقد بين العلماء هذه العيوب مفصلة، ومن شروطها أن يكون الذبح في الوقت المحدد له، وهو من انتهاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.
وينبغي للمسلم إذا أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قال :«إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا»
رواه مسلم.
وهذا المنع على القيِّم رب الأسرة، وأما أولاده فإن أمسكوا فحسن حتى يحظوا بالأجر، وإن أخذوا فلا حرج عليهم إن شاء الله.
8- الدعاء:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» أخرجه الترمذي في الدعوات
قال ابن عبد البر: «وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره،وفي الحديث أيضًا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب التمهيد 6/41
9- التوبة والبعد عن المعاصي :
ومما يجب في هذه العشر وفي كل زمان التوبة النصوح والرجوع إلى الله والإقلاع عن المعاصي والذنوب،قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا) التحريم: 8،
فسارعوا إلى التوبة الصادقة بالطاعة والتحلل من المظالم ورد الحقوق والبعد عن الفواحش.
أمير بن محمد المدري

**********
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة
القرآن الكريم
1- (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ ( (آل عمران/110)
2-( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ( (آل عمران/114)
3-( وَلْتَكُن مِنكُمْ اُمَّـةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (آل عمران/104)
4-( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِـلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْءانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * التَّآئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( (التوبة/111-112)
5-( الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الاَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الاُمُورِ ( (الحج/41)
6-( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (التوبة/71)
7- (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ( (لقمان/17)
إن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه، والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عزّ وجلّ ويباعد من رحمته.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته عظيمة، وقد عده العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وقدمه الله عزّ وجلّ على الإيمان كما في قوله تعالى: { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } .
وقدمه الله عزّ وجلّ في سورة التوبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال تعالى: { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم } .
وفي هذا التقديم إيضاح لعظم شأن هذا الواجب وبيان لأهميته في حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب. وبتحقيقه والقيام به تصلح الأمة ويكثر فيها الخير ويضمحل الشر ويقل المنكر. وبإضاعته تكون العواقب والوخيمة والكوارث العظيمة والشرور الكثيرة، وتتفرق الأمة وتقسو القلوب أو تموت، وتظهر الرذائل وتنتشر، ويظهر صوت الباطل، ويفشو المنكر.
ومن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي:
أولاً: أنه من مهام وأعمال الرسل عليهم السلام، قال تعالى: { ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت }
ثانياً: أنه من صفات المؤمنين كما قال تعالى: { التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين }
على عكس أهل الشر والفساد { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون } .
ثالثاً: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين، قال تعالى: { ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويُسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين } .
رابعاً: من خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: { كُنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتُؤمنون بالله } .
خامساً: التمكين في الأرض، قال تعالى: { الذين إن مّكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبةُ الأمور } .
سادساً: أنه من أسباب النصر، قال تعالى: { ولينصُرَنَّ الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبةُ الأمور } .
سابعاً: عظم فضل القيام به كما قال تعالى: { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً } . وقوله صلى الله عليه وسلم: « من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » [رواه مسلم].
ثامناً: أنه من أسباب تكفير الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم: « فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفّرها الصيام والصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » [رواه أحمد].
تاسعاً: في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للضرورات الخمس في الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفضائل غير ما ذكرنا. وإذا تُرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعُطلت رايته؛ ظهر الفساد في البر والبحر وترتب على تركه أمور عظيمة منها:
1- وقوع الهلاك والعذاب، قال الله عزّ وجلّ: { واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة } .
وعن حُذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » [متفق عليه].
ولما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: “أنهلك وفينا الصالحون؟” قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: « نعم إذا كثُر الخبث » [رواه البخاري].
2- عدم إجابة الدعاء، وقد وردت أحاديث في ذلك منها حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: « مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكم » [رواه أحمد].
3- انتفاء خيرية الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: « والله لتأمرنّ بالمعروف ولتنوهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم » [رواه أبو داود].
4- تسلُّط الفساق والفجار والكفار والكفار، وتزيين المعاصي، وشيوع المنكر واستمراؤه.
5- ظهور الجهل، واندثار العلم، وتخبط الأمة في ظلمة حالكة لا فجر لها. ويكفي عذاب الله عزّ وجلّ لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلط الأعداء والمنافقين عليه، وضعف شوكته وقلة هيبته.
قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: فلو قُدِّر أن رجلاً يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها، وهو مع هذا لا يغضب الله، ولا يتمعَّر وجهه، ولا يحمر، فلا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله، وأقلهم ديناً، وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه.
خطوات الإنكار والأمر:
أولاً: التعريف، فإن الجاهل يقوم على الشيء لا يظنه منكراً، فيجب إيضاحه له، ويؤمر بالمعروف ويبين له عظم أجره وجزيل ثواب من قام به، ويكون ذلك بحسن أدب ولين ورفق.
ثانياً: الوعظ؛ وذلك بالتخويف من عذاب الله عزّ وجلّ وعقابه وذكر آثار الذنوب والمعاصي، ويكون ذلك بشفقة ورحمة له.
ثالثاً: الرفع إلى أهل الحسبة إذا ظهر عناده وإصراره.
رابعاً: التكرار وعدم اليأس فإن الأنبياء والمرسلين أمروا بالمعروف وأعظمه التوحيد، وحذروا من المنكر وأعظمه الشرك، سنوات طويلة دون كلل أو ملل.
خامساً: إهداء الكتاب والشريط النافع.
سادساً: لمن كان له ولاية كزوجة وأبناء، فله الهجر والزجر والضرب.
سابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب من الشخص الرفق والحلم، وسعة الصدر والصبر، وعدم الانتصار للنفس، ورحمة الناس، والإشفاق عليهم، وكل ذلك مدعاة إلى الحرص وبذل النفس.
درجات تغيير المنكر ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » [رواه مسلم].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرّمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً.
وقال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله: فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم، أوله وآخره أُسّه ورأسه، وهو “شهادة أن لا إله إلا الله” واعرفوا معناها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت، وعادوهم وأبغضوا من أحبهم، أو جادل عنهم أو لم يكفرهم، أو قال ما عليّ منهم، أو قال: ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه أو أولاده.
شاع في بعض أوساط الناس الغفلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبروا ذلك تدخلاً في شؤون الغير؛ وهذا من قلة الفهم ونقص الإيمان، فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس! إنكم لتقرؤون هذه الآية: { يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم } وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » [رواه أبو داود].
وتأمل في سفينة المجتمع كما صورها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » [رواه البخاري].
اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، المقيمين لحدودك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

**********
التوبة
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا }
سورة التحريم : 8
ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتاب مدارج السالكين
نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها.
منها:
أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير
فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة
وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة
ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم
فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم
فإنه عاص بترك العلم والعمل فالمعصية في حقه أشد
وفي صحيح ابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل
فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟
قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم“.
فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: “أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي فى أمري
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت“.
وفي الحديث الآخر: “اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانيته أوله وآخره“.
فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه.
…….
وشروط التوبة:
الإقلاع الفوري عن الذنب
والندم على مافات
والعزم على عدم الرجوع
ورد المظالم والحقوق لأهلها إن وجد .
*****
1- التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي وكل تقصير
فلا تترك شئ منها علمته أو جهلته إلا واستغفرت وتبت لله منه
2- المحافظة على أعظم ركن وعمود الدين ( الــصــلاة ) إقامتها وعلى وقتها وخشوعها فهي قرة العيون كيف لا وأنت تقف بين يدي الله سبحانه .
3- قراءة القرآن الكريم :لايمر عليك يوم إلا ومتعت قلبك بتقليب صفحاته وتلاوته والتفكر بآياته وتدبرها ولايخلو جيبك من مصحف سواء في جهاز هاتف أو غيره ليكون لك أعظم رفيق في كل مكان فهو النور والهدى.
4- لايزال لسانك رطباً من ذكر الله فبذكره تطمئن القلوب وترتاح النفوس سواء أذكار صباحية أو مسائية
وفي كل وقت تقضي على صمتك بالذكر والتسبيح والتهليل ولاتجعل للنفس والشيطان عليك مدخلا فهو الحصن الحصين .
5- في خلواتك وبعدك عن الأنظار كن من المتفكرين في خلق السموات والأرض وعظيم خلق الله سبحانه وتأمل حجمك بالنسبة لها
وردد ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك
تفكر في الجنة والمعاد الطيب لأهل التقوى دار الكرامة والخلود لمن عمل صالحا واخلص وصدّق
وتذكر حقارة الدنيا الفانية وأنها إلى زوال
وبهذا يكون لديك الدافع للاستعداد للآخرة وعدم الركون للدنيا.
6- لاتغفل أبدا عن ساعة ستمر بالجميع وأنت منهم
لحظة الفراق والوداع ( الموت ) ،فبذكره يقصر الأمل ويسارع الصادق للعمل
وبقياس هذه الدنيا أمام النعيم في الآخرة يسعد القلب الصادق المنتظر لوعد الله الحق جعلنا الله وإياك ممن فاز .
7- الدعاء في كل أحوالك فلا تكن ممن لايدعو إلا إذا مسته ضراء
بل كن ممن يلتجيء لربه في السراء والضراء، فالدعاء هو العبادة وأنت تتعبد ربك به
ويكفيك من الدعاء أنك تناجي العظيم الرحمن الرحيم .
8- اشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه ونشر الخير وإيصال النفع للناس في عملك مدرستك في السوق في البيت مع أصدقائك وأقربائك
كن مباركا أينما كنت وحاملا للخير ناشرا له أينما توجهت .
9-عليك بصدقة السر وإيصالها لمحتاجها قريب كان أو بعيد في يسرك وعسرك إن كنت تجد المال فلاتبخل وإن كنت لاتجد فلا تحقر من المعروف شيئا وتذكر:
” اتقوا النار ولو بشق تمرة “
10ـ بر الوالدين أحياء بخدمتهما وتلبية حوائجهم وكذلك برهم أمواتاً بالصدقة والدعاء لهم.
11- النوافل والاستمرار والمحافظة عليها وتذكر الفوز بمحبة الله كما جاء في الحديث القدسي ” ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه “

******
{ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ }
يوسف:111
قصص القرآن الكريم
معنى القصص:
القص لغة : تتبع الأثر . يقال : قصصتُ أثره : أي تتبعته ، وقصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية ، والنبوات السابقة ، والحوادث الواقعة _ وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي ، وتاريخ الأمم ، وذكر البلاد والديار . وتتبع آثار كل قوم ، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه .
قال الشيخ محمد بن عثيمين:
القصص والقص لغة : تتبع الأثر
وفي الاصطلاح : الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضًا .
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى : ) ومن أصدق من الله حديثًا ( وذلك لتمام مطابقتها للواقع .
وأحسن القصص لقوله تعالى : ) نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ( وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى .
وأنفع القصص لقوله تعالى : ) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ( وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق([1])
أنواع القصص في القرآن:
والقصص في القرآن ثلاثة أنواع :
النوع الأول : قصص الأنبياء ، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم ، والمعجزات التي أيدهم الله بها ، وموقف المعاندين منهم ، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين . كقصة نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وهارون ، وعيسى ، ومحمد ، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين ، عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام .
النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة ، وأشخاص لم تثبت ثبوتهم ، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وطالوت وجالوت ، وابني آدم ، وأهل الكهف ، وذي القرنين ، وقارون ، وأصحاب السبت ، ومريم ، وأصحاب الأخدود ، وأصحاب الفيل ونحوهم.
النوع الثالث : قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله كغزوة بدر واُحد في سورة آل عمران ، وغزوة حنين وتبوك في التوبة ، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ، والهجرة ، والإسراء ، ونحو ذلك .
فوائد قصص القرآن:
وللقصص القرآني فوائد نجمل أهمها فيما يأتي :
1- إيضاح أسس الدعوة إلى الله ، وبيان أصول الشرائع التي يبعث بها كل نبي : ) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ( [الأنبياء : 25].
2- تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجندة ، وخذلان البطل وأهله: ) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ( [هود: 12] .
3- تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم .
4- إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال .
5- مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى ، وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل ، كقوله تعالى : ) كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسة من قبل أن تنزل التوراة ، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ( [آل عمران: 93].
6- والقصص ضرب من ضروب الأدب ، يصغى إليها السامع ، وترسخ عبره في النفس : ) لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ( [يوسف: 111] ([2]).
7-بيان حكم الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى : ) ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر (
8- بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين : ) وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ( .
9- بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى : ) إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ( .
10- تسلية النبي عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى : ) وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ( .
11- ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى : ) فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ( .
12- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى : ) أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها (.
13- إثبات رسالة النبي فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى : ) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ( وقوله ) ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ( ([3]).
تكرار القصص وحكمته :
يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذي تكرر في غير موضع ، فالقصة الواحدة قد يتعدد ذكرها في القرآن.
ومن القصص القرآنية مالا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر([4]) .
ومن حكمة هذا:
1- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها . فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة ، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر ، وتصاغ في قالب غير القالب ، ولا يمل الإنسان من تكرارها ، بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى.
2- قوة الإعجاز _ فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في التحدي .
3- الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس ، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام . كما هو الحال في قصة موسى مع فرعون ، لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل _ مع أن القصة لا تكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها .
4- اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة _ فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام ، وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال ([5])
5- بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها .
6- مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبًا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية .
7- ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض ([6]).
الهوامش
([1]) أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (52-53).
([2]) مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان (317-318)
([3]) أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (53-54).
([4]) أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (54-55).
([5])مباحث في علوم القرآن للقطان (318-319).
([6])أصول في التفسير للعثيمين (54-55).

******
الاعتصام بحبل الله
منزلة الاعتصام
ثم ينزل القلب منزل الاعتصام .
وهو نوعان : اعتصام بالله ، واعتصام بحبل الله ، قال الله تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” وقال “واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير”
والاعتصام افتعال من العصمة ، وهو التمسك بما يعصمك ، ويمنعك من المحذور والمخوف ، فالعصمة : الحمية ، والاعتصام : الاحتماء ، ومنه سميت القلاع : العواصم ، لمنعها وحمايتها .
ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله ، والاعتصام بحبله ، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين .
فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة ، والاعتصام به يعصم من الهلكة ، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده ، فهو محتاج إلى هداية الطريق ، والسلامة فيها ، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له ، فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ، وأن يهديه إلى الطريق ، والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها .
فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل ، والاعتصام بالله ، يوجب له القوة والعدة والسلاح ، والمادة التي يستلئم بها في طريقه ، ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله ، بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى .
فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله .
وقال ابن مسعود : هو الجماعة ، وقال : عليكم بالجماعة ، فإنها حبل الله الذي أمر به ، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة .
وقال مجاهد و عطاء : بعهد الله ، وقال قتادة و السدي وكثير من أهل التفسير : هو القرآن .
قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع ، وعصمة من تمسك به ، ونجاة من تبعه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو حبل الله المتين ، ولا تختلف به الألسن ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا يشبع منه العلماء .
وقال مقاتل : بأمر الله وطاعته ، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى .
وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ، ويسخط لكم ثلاثا ، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويسخط لكم قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال رواه مسلم في الصحيح .
قال صاحب المنازل : الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته ، مراقبا لأمره .
ويريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها ، لا لمجرد العادة ، أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر ، كما قال طلق بن حبيب في التقوى : هي العمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وترك معصية الله على نور من الله ، تخاف عقاب الله .
وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله : ” من صام رمضان إيمانا واحتسابا ” و ” من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ” فالصيام والقيام : هو الطاعة والإيمان : مراقبة الأمر . وإخلاص الباعث : هو أن يكون الإيمان الآمر لا شيء سواه . والاحتساب : رجاء ثواب الله
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل
وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه ، والامتناع به ، والاحتماء به ، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ، ويعصمه ويدفع عنه ، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد ، والله يدافع عن الذين آمنوا ، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ، ويحميه منه ، فيدفع عنه الشبهات والشهوات ، وكيد عدوه الظاهر والباطن ، وشر نفسه ، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها ، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه ، فتفقد في حقه أسباب العطب ، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها ، ويدفع عنه قدره بقدره ، وإرادته بإرادته ، ويعيذه به منه .
وفي قول الله تعالى”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ”
في هذه الآية الكريمة أمرًا مهمًا عظيمًا ألا وهو الاعتصام بحبل الله المتين وإنما يكون ذلك بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالدين الحنيف والثبات عليه حتى آخر العمر، وذلك يتضمن بالتأكيد ترك البدع الفاسدة والأفكار الكاسدة التي يلقيها شياطين الأنس ليضلوا الناس عن المحجة البيضاء التي كان عليه سلف هذه الأمة وأكابرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من الذين اتبعوهم بإحسان، وكانوا نعم القدوة والمثل الذي يحتذى به، إذ توحدوا وتآلفوا ووجهوا أنظارهم نحو هدف واحد فإذا بهم قد اجتمعوا على كلمة الحق ووجهوا القصد نحو نصرة هذا الدين العظيم ملتزمين بما فيه النجاح والفلاح كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتحقق لهم المجد العظيم والخير العميم ونالوا عزًا لا يطاولهم فيه أحد، بدءًا من البعثة المحمدية المباركة ومرورًا بعهد الخلفاء الراشدين البررة ومن جاء بعدهم ممن نور الله قلوبهم بالإيمان فانقشعت بهم ظلمات حالكة عصفت بالبلاد والديار، كيف لا وقد توحدوا على درب التقوى وجمعهم الإخلاص لله رب العالمين والتضحية والبذل، قائمين بالمعروف ناهين عن المنكر امتثالًا لقول الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب} المائدة
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قام خطيبًا في حجة الوداع فقال: ( إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم) – وفي رواية: (مما تخافون من أعمالكم فاحذروا، يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون أخوة ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ).
وهنا يجدر بنا أن نتدبر ونعي هذا البيان العظيم من كلام سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالاعتصام الصحيح والوحدة السليمة هي التي تقوم على التمسك بالحق والعمل بمثل هذه المبادىء العالية التي تقي البلاد من كثير من الشرور التي يسعى إليها صاحب الغرض الدنيىء كما كان وما زال من يوم أن ساءه ما رأى من تآلف وتعاون وثيق قائم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقسم الرجل ماله شطرين ليعين أخاه المسلم، ويهب له دارًا من إحدى الدارين وبستانًا وأرضًا رغبة فيما عند الله وما عند الله خير وأبقى فيأتي من يريد زرع الفتنة ويجلس إلى نفر من الأوس والخزرج فيحدثهم بما كان بينهم في الجاهلية وينشدهم بعض الشعر مما قيل في تلك الحروب بغية إيقاع الفتنة والشحناء حتى كادت الحرب أن تقع بين طائفتين من المسلمين ولكن الخبر يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بتوفيق الله على إيقاف نار الفتنة ويقول: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بين قلوبكم ).
إخوة الإيمان: إن في هذا توجيه إلى سبيل السلامة في الآخرة والعزة في الدنيا وذلك بالإعتصام الصحيح بالشريعة الغراء بالتمسك بالدين والحكم بحكمه وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الشريعة،
عملاً بقول الله تعالى : ” وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ “
وبقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: ( إن اللَّه تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها).

******
“وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ”
“وَالۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ الۡقَتۡلِ”
سورة البقرة: 217،191
ما الفتنة ؟
الفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثيرة تقع على الشرك وهو أعظم الفتن كما قال الله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ[1] أي حتى لا يكون شرك ،
وقال جل وعلا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ[2] وتقع الفتنة أيضا على التعذيب والتحريق كما قال جل وعلا: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ[3] وقال جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ[4] والمراد هنا العذاب والتحريق فتنوهم يعني عذبوهم. وتطلق الفتنة أيضا على الاختبار والامتحان كما قال جل وعلا: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً[5] يعني اختبارا وامتحانا وقال جل وعلا: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ[6] يعني اختبارا وامتحانا حتى يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة الله ومن يقوم بحق الله ويتجنب محارم الله ويقف عند حدود الله ممن ينحرف عن ذلك ويتبع هواه. وتقع أيضا على المصائب والعقوبات كما قال تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً[7] يعني: بل تعم.
جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة أنهم قالوا: “ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت”وكانت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه الحق واشتبهت عليه الأمور فتابعهم حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه بالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة ثم عمت هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس لهم بها صلة وليسوا في زمرة الظالمين وجرى بسببها ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وما حصل يوم الجمل ويوم صفين كلها بأسباب الفتنة التي وقعت بسبب ما فعله جماعة من الظلمة بعثمان رضي الله عنه فقام قوم وعلى رأسهم معاوية بالمطالبة بدم القتيل عثمان رضي الله عنه وطلبوا من علي رضي الله عنه وقد بايعه المسلمون خليفة رابعا وخليفة راشدا تسليمهم القتلة وعلي رضي الله عنه أخبرهم أن المقام لا يتمكن معه من تسليم القتلة ووعدهم خيرا وأن النظر في هذا الأمر سيتم بعد ذلك وأنه لا يتمكن من قتلهم الآن وجرى من الفتنة والحرب يوم الجمل ويوم صفين ما هو معلوم حتى قال جمع من السلف رضي الله عنهم منهم الزبير رضي الله عنه: إن الآية المذكورة نزلت في ذلك. وهذه أول فتنة وقعت بين المسلمين بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام فأصابت جما غفيرا من الصحابة وغير الصحابة وقتل فيها عمار بن ياسر وطلحة بن عبيد الله وهو من العشرة المبشرين بالجنة والزبير وهو من العشرة أيضا وقتل فيها جمع غفير من الصحابة وغيرهم في الجمل وفي صفين بأسباب هذه الفتنة.
وتقع الفتنة أيضا بأسباب الشبهات والشهوات فكم من فتن وقعت لكثير من الناس بشبهات لا أساس لها كما جرى للجهمية والمعتزلة والشيعة والمرجئة وغيرهم من طوائف أهل البدع فتنوا بشبهات أضلتهم عن السبيل وخرجوا عن طريق أهل السنة والجماعة بأسبابها وصارت فتنة لهم ولغيرهم إلا من رحم الله.
وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما روي ذلك عن علي مرفوعا تكون فتن. قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: “كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم..”الحديث. والمقصود أن الفتن فتن الشهوات والشبهات والقتال وفتن البدع كل أنواع الفتن – لا تخلص منها ولا النجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى.
وجميع ما يقول الناس وما يتشبث به الناس وما يتعلق به الناس في سلمهم وحربهم وفي جميع أمورهم – يجب أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[8] يعني أحسن عاقبة هذا هو الطريق وهذا هو السبيل فالرد إلى كتاب الله هو الرد إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
وهكذا يقول جل وعلا: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[9] وتحكيم الرسول هو تحكيم الكتاب والسنة قال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[10] فما عدا حكم الله فهو من حكم الجاهلية قال جل وعلا: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[11] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[12] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[13] فالمخلص من الفتن والمنجي منها بتوفيق الله هو بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بالرجوع إلى أهل السنة وعلماء السنة الذين حصل لهم الفقه في كتاب الله عز وجل والفقه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرسوهما غاية الدراسة وعرفوا أحكامهما وساروا عليهما فجميع الأمة من إنس ومن جن وعجم وعرب ومن رجال ونساء يجب عليهم أن يحكموا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يسيروا على نهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في السلم والحرب في العبادات والمعاملات وفي جميع ما افترق فيه الناس في أسماء الله وصفاته في أمر البعث والنشور في الجنة والنار وفي كل شيء ومن ذلك الحروب التي يثيرها بعض الناس يجب أن يحكم فيها شرع الله.
وهكذا الإعداد للحرب ومن يستعان به في الحرب ومن لا يستعان به كله يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما وقع في هذا العام في الحادي عشر من المحرم من فتنة حاكم العراق – عامله الله بما يستحق – في عدوانه على دولة الكويت واجتياحه لها وما حصل من تهديده لهذه البلاد ودول الخليج هذه من الفتن أيضا التي يجب أن يحكم فيهـا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ولا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا الرجل الفاجر قد أتى منكرا وإثما عظيما وعدوانا سافرا لا مبرر له. ولو كان من دعاة الإسلام ومحكمي الشريعة لم يجز له أن يغزو طائفة من الناس لا الكويت ولا غيرها إلا بعد الدعوة وبعد النظر في الشبه التي يدعيها عليهم ومدى تحكيمه لشرع الله في ذلك. أما أن يغزو بلادا آمنة ويقتل وينهب ويسبي ولا يبالي فذلك منكر عظيم وعدوان أثيم لا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخر ثم بعد ذلك يلبس لباس الإسلام وينافق ويدعي أنه يطلب الجهاد وأنه يحمي الحرمين وهذا من النفاق والكفر البواح والتلبيس. ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية وجميع النحل الملحدة المنابذة للإسلام كالعلمانية وغيرها كلها ضد الإسلام وأهلها أكفر من اليهود والنصارى. لأن اليهود والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم ونساؤهم المحصنات والملاحدة لا يحل طعامهم ولا نساؤهم وهكذا عباد الأوثان من جنسهم لا تباح نساؤهم ولا يباح طعامهم. فكل ملحد لا يؤمن بالإسلام هو شر من اليهود والنصارى. فالبعثيون والعلمانيون الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام وهكذا من يسمون بالشيوعيين ويسمون بالاشتراكيين كل النحل الملحدة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يكون كفرهم وشرهم أكفر من اليهود والنصارى وهكذا عباد الأوثان وعباد القبور وعباد الأشجار والأحجار أكفر من اليهود والنصارى ولهذا ميز الله أحكامهم وإن اجتمعوا في الكفر والضلال ومصيرهم النار جميعا لكنهم متفاوتون في الكفر والضلال وإن جمعهم الكفر والضلال فمصيرهم إلى النار إذا ماتوا على ذلك. لكنهم أقسام متفاوتون: فإذا أراد البعثي أن يدعي الإسلام فلينبذ البعثية أو الاشتراكية والشيوعية ويتبرأ منها ويتوب إلى الله من كل ما يخالف الإسلام حتى يعلم صدقه ثم إذا كان هذا العدو الفاجر الخبيث صدام حاكم العراق: إذا أراد أن يسلم ويتوب فلينبذ ما هو عليه من البعثية ويتبرأ منها ويعلن الإسلام ويرد البلاد إلى أهلها ويرد المظالم إلى أهلها ويتوب إلى الله من ذلك ويعلن ذلك ويسحب جيشه من الكويت ويعلن توبته إلى الله ويحكم الشريعة في بلاده حتى يعلم الناس صدقه. والمقصود أن جهاده من أهم الجهاد وهو جهاد لعدو مبين حتى ينتقم منه وترد الحقوق إلى أهلها وحتى تهدأ هذه الفتنة التي أثارها وبعثها وسبب قيامها فجهاده من الدول الإسلامية متعين وهذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية ومن ساعدها جهادهم له جهاد شرعي والمجاهد فيها يرجى له إذا صلحت نيته الشهادة إن قتل والأجر العظيم إن سلم إذا كان مسلما. أما ما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين فهذا حكمه معروف عند أهل العلم والأدلة فيه كثيرة والصواب ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين للضرورة إذا دعت إلى ذلك لرد العدو الغاشم والقضاء عليه وحماية البلاد من شره إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة بمن يظن فيهم أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو المشترك. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا في مكة استعان بمطعم بن عدي لما رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أبي طالب فاستجار بغيره فلم يستجيبوا فاستجار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعت الضرورة إلى ذلك وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى يطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم واستعان بعبد الله بن أريقط في سفره وهجرته إلى المدينة – وهو كافر – لما عرف أنه صالح لهذا الشيء وأن لا خطر منه في الدلالة وقال يوم بدر “لا أستعين بمشرك” ولم يقل لا تستعينوا بل قال: “لا أستعين” لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهم والحمد لله معه جماعة مسلمون وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم. وفي يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه فقال: أغصبا يا محمد فقال: “لا ولكن عارية مضمونة ” واستعان باليهود في خيبر لما شغل المسلمون عن الحرث بالجهاد وتعاقد معهم على النصف في خيبر حتى يقوموا على نخيلها وزروعها بالنصف للمسلمين والنصف لهم وهم يهود لما رأى المصلحة في ذلك. فاستعان بهم لذلك وأقرهم في خيبر حتى تفرغ المسلمون لأموالهم في خيبر في عهد عمر فأجلاهم عمر رضي الله عنه. ثم القاعدة المعروفة يقول الله جل وعلا: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[14]والمسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو الآخر وأمكن الاستعانة به على عدو آخر أشر منه فلا بأس. ومعلوم أن الملاحدة من البعثيين وأشباههم أشر من اليهود والنصارى، والملاحدة كلهم أشر من أهل الكتاب وشرهم معروف فالاستعانة العارضة بطوائف من المشركين لصد عدوان العدو الأشر والأخبث لدفع عدوانه والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره أمر جائز شرعا حسب الأدلة والقواعد الشرعية أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم وتفصيل ذلك فيما يلي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرف لها تستشرفه فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل ” أخرجه البخاري في صحيحه فهذه الفتن هي الفتن التي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها بل هي ملتبسة فهذه يجتنبها المؤمن ويبتعد عنها بأي ملجأ ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: “يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن” أخرجه البخاري في الصحيح ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أفضل ؟ قال “مؤمن مجاهد في سبيل الله ” قيل ثم من ؟ قال”مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره” والمقصود أن هذا عند خفاء الأمور وعلى المؤمن أن يجتنبها أما إذا ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق فالواجب أن يكون مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل كما قال صلى الله عليه وسلم “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” قيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما ؟ قال “تحجزه عن الظلم فذلك نصره” أي منعه من الظلم هو النصر. ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد ابن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وجماعة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي. لأنه أولى الطائفتين بالحق وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن عليا مظلوم وأن الواجب أن ينصر وأنه هو الإمام الذي يجب أن يتبع وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة المطالبة بقتل عثمان. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ما قال فاعتزلوا قال: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[15] فإذا عرف الظالم وجب أن يساعد المظلوم لقوله سبحانه: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ[16] والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابه والمبغي عليه علي وأصحابه فبهذا نصرهم أعيان الصحابة نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم. وقال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة الخوارج: “تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وأصحابه فاتضح بذلك أنهم أولى الطائفتين بالحق”. وقال صلى الله عليه وسلم في أمر عمار: “تقتل عمارا الفئة الباغية” فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين. فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحة والزبير يوم الجمل ومعهم عائشة رضي الله عنها لكن لم يصيبوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعا وهذه هي القاعدة الشرعية في حق المجتهدين من أهل العلم أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد إن أخطأ الحق أجر الاجتهاد كما قال صلى الله عليه وسلم: “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر” متفق على صحته فكل فتنة تقع على يد أي إنسان من المسلمين أو من المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها فيكون المؤمن مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل وبهذا ينصر الحق وتستقيم أمور المسلمين وبذلك يرتدع الظالم عن ظلمه ويعلم طالب الحق أن الواجب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان عملا بقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[17] فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد المسلمين وقتال من يتعدى على المسلمين لظلمه وكفره حق وبر ونصر للمظلوم وردع للظالم فقتال المسلمين لصدام وأشباهه من البر ومن الهدى ويجب أن يبذلوا كل ما يستطيعونه في قتاله وأن يستعينوا بأي جهة يرون أنها تنفع وتعين في ردع الظالم وكبح جماحه والقضاء عليه وتخليص المسلمين من شره ولا يجوز للمسلمين أيضا أن يتخلوا عن المظلومين ويدعوهم للظالم يلعب بهم بأي وجه من الوجوه بل يجب أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم في القليل والكثير. فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يكونوا على بصيرة فيما يأتون وفيما يذرون وأن يحكموا كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم في كل شيء، كما قال الله سبحانه وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله[18] الآية، وقوله عز وجل فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر[19]الآية، وعليهم أن يدرسوا الكتاب والسنة دراسة الطالب للحق المريد وجه الله والدار الآخرة الذي يريد أن ينفذ حكم الله في عباد الله وأن يحذروا الهوى فإن الهوى يهوي بأهله إلى النار قال تعالى: وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[20] وقال جل وعلا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[21] فماذا يظن العاقل ذو البصيرة لو أن صداما ترك له المجال فعاث في الجزيرة فسادا وساعده من مالأهم على المساعدة من الجنوب والشمال على باطله ماذا يترتب على ذلك من الكوارث العظيمة والفساد الكبير والشر الكثير لو تمكن من تنفيذ خططه الخبيثة ولكن من نصر الله جل وعلا ورحمته وفضله وإحسانه أن تنبه ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية لخبثه وشره وما انطوى عليه من الباطل وما أسسه من الشر والفساد فاستعانوا بالقوات المتعددة الجنسيات على حربه والدفاع عن الدين والبلاد حتى أبطل الله كيده وصده عن نيل ما أراد. ونسأل الله أن يحسن العاقبة للمسلمين وأن يكفينا شره وشر غيره وأن ينصر جيوشنا الإسلامية ومن ساعدهم على حاكم العراق حتى يرجع عن ظلمه ويسحب جيشه من الكويت ويوقف عند حده كما نسأله سبحانه أن يوفق جيوشنا جميعا للفقه في الدين وأن يكفينا شر ذنوبنا وشر تقصيرنا وأن يكفينا شر جميع الكفرة من جميع الأجناس وأن يردهم إلى بلادهم ونحن سالمون من شرهم وأن يهدي منهم من سبقت له السعادة إلى الإسلام وأن ينقذهم مما هم فيه من الكفر نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يردهم إلى الحق والهدى وأن يكفينا شرهم جميعا من بعثيين ونصارى وغيرهم نسأل الله أن يهديهم للإسلام ويكفينا شرهم ويبعد من بقي على الكفر منهم إلى بلاده بعد سلامة المسلمين وبعد القضاء على عدو الله حاكم العراق وجيشه المساعد له وأن يختار للعراق رجلا صالحا يحكم فيهم شرع الله كما نسأله أن يولي على جميع المسلمين من يحكم فيهم شرع الله ويقودهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكفي المسلمين شر ولاتهم الذين يخالفون شرع الله وأن يصلح ولاة المسلمين وقادتهم ويهديهم صراطه المستقيم وأن يولي على المسلمين جميعا في كل مكان خيارهم وأن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يكفينا شر ذنوبنا جميعا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يجعل ما نزل بالكويت وما حصل من المحنة العظيمة والفتنة الكبيرة هذه الأيام موعظة للجميع وسببا لهداية الجميع ويقظتهم وأن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على طاعة الله ورسوله وعلى إعداد الجيش الكافي الذي يغنيها عن جميع أعداء الله ونسأل الله أن يهدي جيراننا جميعا للتمسك بكتاب الله وأن يجمعهم على الحق والهدى وأن يعينهم على طاعة الله ورسوله وأن يعيذهم من مَنْ بينهم من الأعداء والمنافقين المحاربين لله ورسوله الذين يدعون إلى ضد كتاب الله وإلى ضد سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله أن يبطل كيد أعداء الله ويفرق شملهم ويوفق دعاة الحق لما فيه رضاه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجمع كلمتنا جميعا معشر المسلمين على الحق والهدى أينما كنا وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا إنه جواد كريم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الشيخ عبد العزيز بن باز
[1] سورة الأنفال الآية 39.
[2] سورة البقرة الآية 217.
[3] سورة الذاريات الآية 14.
[4] سورة البروج الآية 10.
[5] سورة الأنبياء الآية 35.
[6] سورة التغابن الآية 15.
[7] سورة الأنفال الآية 25.
[8] سورة النساء الآية 59.
[9] سورة النساء الآية 65.
[10] سورة المائدة الآية 50.
[11] سورة المائدة الآية 44.
[12] سورة المائدة الآية 45.
[13] سورة المائدة الآية 47.
[14] سورة الأنعام الآية 119.
[15] سورة الحجرات الآية 9.
[16] سورة الحجرات الآية 9.
[17] سورة المائدة الآية 2.
[18] سورة الشورى الآية 10.
[19] سورة النساء الآية 59.
[20] سورة ص الآية 26.
[21] سورة القصص الآية 50

******
التوكل على الله
الأمر بالتوكل:
فإن التوكل على الله عبادة الصادقين، وسبيل المخلصين، أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين، وأولياءه المؤمنين، قال رب العالمين: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِير}
وقال :{ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
وأمر به المؤمنين:
فقد قال الله تعالى في سبعة مواضع من القرآن :{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}
تعريف التوكل:
فما هو التوكل؟
هو في اللغة الاعتماد على الغير في أمر ما، واصطلاحا: صدق اعتماد القلب على اللّه تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة [العلوم والحكم لابن رجب (409)].
وقال الجرجاني رحمه الله: التوكل هو الثقة بما عند اللّه، واليأس عما في أيدي الناس
[التعريفات (74)].
التوكل والأخذ بالأسباب.
لابد هنا من لفت الانتباه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أنّ التوكل لا ينافي أخذ الأسباب.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول اللّه أعقلها وأتوكّل، أو أطلقها وأتوكّل؟ -لناقته- فقال صلى الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكّل»
سنن الترمذي
وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل اللّه تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : «لا تبشّرهم فيتكلوا» دليل على أنه لابد من بذل الأسباب وعدم الاتكال.
الأمر الثاني: تتخذ الأسباب وإن كانت ضعيفة في نفسها.
ولذلك أمر الله تعالى أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه، وهل ضربة الصحيح للأرض منبعة للماء؟ لا، ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لابد من اتخاذ السبب ولو كان ضعيفاً، فالأمر أمره، والكون كونه، ولكن لابد من فعل الأسباب.
ولما أراد الله أن يطعم مريم وهي في حالة وهن وضعف أمرها أن تهز جذع النخلة؛ لأن السبب يتخذ ولو ضعف.
الأمر الثالث: أن لا يعتمد عليها، وإنما يجعل اعتماده على الله تعالى.
ابذل السبب ولو كان يسيراً، واعلم أنّ الله هو مسبب الأسباب، ولو شاء أن يحول بين السبب وأثره لفعل سبحانه، ولذا لما أُلقي إبراهيم في النار لم يحترق لأن الله قدر ذلك، وإسماعيل عليه السلام لما أمرَّ أبوه السكين على عنقه وهي سبب في إزهاق الروح لم تزهق روحه لأن الله لم يأذن في ذلك.
فلا يعتمد إلا على الله، وتتخذ الأسباب، لأن الله يقدر الأمور بأسبابها.
ويتأكد التوكل على الله في بعض المواطن:
المسلم عليه أن يعتمد على الله في أمره كله، ويتأكد في مواضع، ذكرها بعضها الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، منها:
عند النوم:
فعن البراء بن عازب رضي اللّه عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الّذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهنّ آخر ما تتكلم به».
عند نزول الفاقة:
ففي جامع الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ».
عند الإعراض عن الأعداء:
قال تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلً} النساء: 81
إذا أعرض الناس عنك:
قال تعالى :{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهو رب العرش العظيم} التوبة: 129
عند مسالمة الأعداء:
قال تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} الأنفال: 61
عند مواجهة الأعداء:
قال تعالى: {قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ * قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ}
إبراهيم: 10-12
عند نزول المصائب وحلول الكرب:
قال تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}
التوبة: 51
وفي الصحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ :«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».
وفي سنن أبى داود قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».
عند الخروج من المنزل:
ففي سنن أبى داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ»؟
إذا تسرب إلى النفس شيء من التطير:
ففي السنن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطيرة شرك». قال ابن مسعود: وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.
والمسلم الحق عليه أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله، فلا أشقى من عبد وكله الله إلى نفسه، قال سبحانه :{ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلً} النساء : 81
نماذج من توكل الأنبياء عليهم السلام والصالحين:
1/ لما مر ركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي بأن أبا سفيان جمع لهم،وذلك بعيد أحد- قالوا : {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ } ـ أي زاد المسلمين قولهم ذلك ـ {إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ } آل عمران : 173، 174
وقد ثبت في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال :{حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}.
2/ عن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ –شجر شوك- فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ –شجرى الطلح- فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَا، فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم
3/ قال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: إَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ :«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا» البخاري ومسلم
وفي ذلك يقول ربنا:{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} التوبة: 40
4/ ولما لحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بسواري كسرى وهو مطارد، قال له :«كَأَنِّى بِكَ قَدْ لَبِسْتَ سِوَارَىْ كِسْرَى» سنن البيهقي
فأي ثقة هذه التي امتلأ بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم!
5/ قال تعالى عن هود عليه السلام : {قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ}هود: 53-56
فكيدوني جميعا لا يتخلف منكم أحد.
6/ قال تعالى عن نوح عليه السلام: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ} يونس: 71
ومعنى الآية: أعدُّوا أمركم، وادعوا شركاءكم، ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستترًا بل ظاهرًا منكشفًا، ثم اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ولا تمهلوني ساعة من نهار.
7/ قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: {قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ * وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} يونس: 66-67
8/ قال تعالى عن موسى عليه السلام: {فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ *وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ * فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ * فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} الشعراء: 53-62
البحر أمامه، وفرعون خلفه، والجبال الشاهقة ترى عن يمينه وشماله، ومع ذلك :{ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}.
9/ وقال عن مؤمن آل فرعون: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} غافر: 44-46
أي: ” ألجأ إليه وأعتصم، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم” تفسير السعدي، ص 738
10/ ولما فوَّضت أم موسى أمرها إلى الله حفظ ابنها ورده إليها، قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} القصص: 7-8
ثمرات التوكل :
النصر:
قال تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} آل عمران: 160
فأمر الله بالتوكل بعيد ذكره للنصر ليدلل على أن من أسبابه الاعتماد عليه.
الحفظ من الشيطان الرجيم:
قال تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} النحل: 99
الشجاعة:
فمن امتلأ قلبه بالتوكل على الله فمم يخاف؟
ولهذا كان سيد المتوكلين سيد الشجعان، ففي الصحيحين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، ثُمَّ قَالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا».
والعُري غير المسرج. و«لم تراعوا»: أي روعا مستقراً، أو روعا يروعكم، و«وجدناه بحراً»: أي واسع الجري.
وفي الزهد لهناد بن السري أن شقيق بن سلمة أبو وائل قال: خرجنا في ليلة مخوفة، فمررنا بأجمة –الشجر الكثير الكثيف الملتف- فيها رجل نائم، وقيد فرسه فهي ترعى عند رأسه فأيقظناه، فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال: إنّي أستحي من ذي العرش أن يعلم أنّي أخاف شيئا دونه، ثم وضع رأسه فنام.
الرزق:
ففي سنن الترمذي وابن ماجة: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا».
تغدو: تذهب أول النهار، وتروح: ترجع آخر النهار.
دليل على صدق الإيمان:
قال تعالى :{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} الأنفال: 2
وفي سبعة مواضع في القرآن الكريم :{ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}.
وذا قال سعيد بن جبير رحمه الله :”التوكل على الله جماع الإيمان”
الزهد لهناد
وقال ابن القيم رحمه الله: “التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة” المدارج 2/118
الكفاية والحماية والرعاية:
قال تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلً} النساء: 81
وقال: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} الطلاق:3
وقال: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} الأنفال: 49
في التوكل لابن أبي الدنيا: عن عون بن عبد اللّه قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شي ء ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاة، فقال له: يا هذا مالي أراك مكتئبا حزينا؟ قال: فكأنّه ازدراه فقال: لا شيء. قال صاحب المسحاة: ألدنيا؟ فإنّ الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البرّ والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر، يفصل بين الحقّ والباطل.
فلمّا سمع ذلك منه كأنّه أعجبه، فقال: لما فيه المسلمون.
قال: فإنّ اللّه سينجّيك بشفقتك على المسلمين، وسل، فمن ذا الّذي سأل اللّه تعالى فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه وتوكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه؟ فدعا اللهم سلمني وسلم مني، فتمحّلت، ولم تصب منهم أحدا.
نيل محبة الله:
قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} آل عمران: 159
وأعظم ثمرة جنة الله:
قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ} العنكبوت: 58-59
وفي الصحيحين عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ». ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ»؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ َلَا يَسْتَرْقُونَ، ولا يكتوون، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».
التوكل لا يكون إلا على الله:
يسوغ: لولا الله ثم فلان إن كان فلان سبباً، وليس يجوز: توكلت على الله ثم عليك، وأقبح منه: توكلت على الله وعليك، فإن الله تعالى يقول: {وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ}، {أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلً}، وقال: { وعلى الله فليتوكل المؤمنون}، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.
فالاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه لا شيء فيها، أما التوكل فعل القلب لا يكون إلا على الله تعالى.

******

صيام الست من شوال
إن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل، إن عمل المؤمن عملٌ دائم لا ينقضي إلا بالموت، واتْلوا قول ربكم تبارك وتعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر:99]،
وقال الله سبحانه: ﴿يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
[آل عمران: 102]،
فلئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل؛ فإن زمن العمل لم ينقطع، ولئن انقضى صيام رمضان؛
فإن الصيام لا يزال مشروعًا ولله الحمد، «فمَن صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر»(1)، وقد سَنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صيام يوم الإثنين والخميس وقال:
«إن الأعمال تُعرض فيهما على الله فأحبُ أن يعرضَ عملي وأنا صائم»(2)،
وأوصى ثلاثةً من أصحابه: أبا هريرة، وأبا ذر، وأبا الدرداء،
«أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر»(3)،
وقال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله»(4)،
وحَث على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام،
وروي عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان لا يدعُ صيامها»(5)،
وقال في صوم يوم عرفة: «يكفّر سنةً ماضية ومستقبلة»(6)؛
يعني: لغير الحاج، فأما الحاج فلا يصوم بعرفة، وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»(7)،
وقال في صوم يوم العاشر منه: «يكفّر سنةً ماضية»(8)،
عائشة رضي الله عنها: «ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصوم في شهرٍ – تعني: صومَ تطوّع – ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كله»(9).
ولئن انقضى قيامُ رمضانَ فإن القيام لا يزال مشروعًا كلَ ليلة من ليالي السنة حثّ عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – ورغّب فيه وقال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل»(10)،
وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم: «أنَّ الله تعالى يَنزِلُ كلّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا حين يبقَى ثُلثُ الليلِ الآخِر فيقول: مَن يَدعُوني فأَستجيبَ له ؟ مَن يَسْألُني فأُعْطِيَهُ ؟ مَن يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ ؟»(11).
فاتّقوا الله وبادروا أعماركم بأعمالكم، وحقِّقوا أقوالكم بأفعالكم؛ فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله، و«إن الكيّس مَن دانَ نفسه – أي: حاسبها – وعملَ لِما بعد الموت والعاجزُ مَن اتْبَعَ نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»(12) .
لقد يسّر الله لكم سبلَ الخيرات وفتح أبوابها، ودعاكم لدخولها وبيَّن لكم ثوابها، «فهذه الصلوات الخمس آكدُ أركان الإسلام بعد الشهادتين هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان»(13)،
«مَن أقامها كانت كفارةً له ونجاةً يوم القيامة»(14)،
شرعها الله لكم و«أكملها بالرواتب التابعة لها،
والرواتب التابعة لها اثنتا عشر ركعة، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين،
وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر،
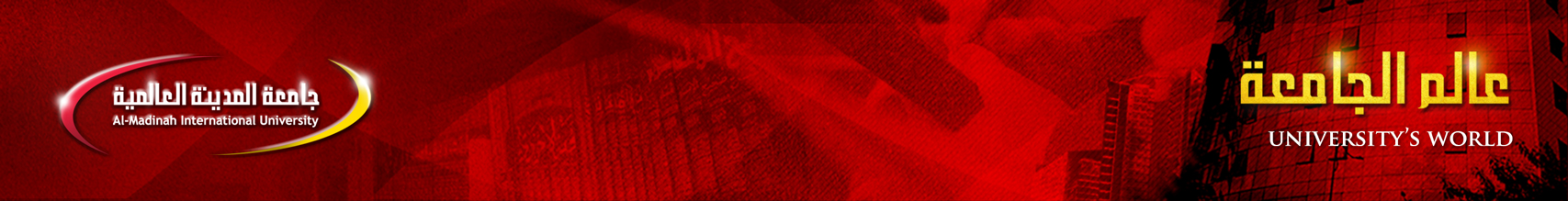 MEDIU World جامعة المدينة العالمية مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية، ومقرها ماليزيا وهي مرخصة من وزارة التعليم العالي الماليزية، البرامج معتدمة من هيئة الاعتمادات الماليزية.
MEDIU World جامعة المدينة العالمية مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية، ومقرها ماليزيا وهي مرخصة من وزارة التعليم العالي الماليزية، البرامج معتدمة من هيئة الاعتمادات الماليزية.
