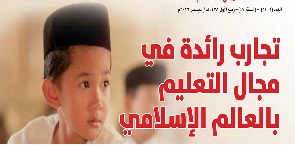الجهة الناشرة: جريدة الاتحاد
تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2015م
د. فليح مضحي أحمد السامرائي
يعد المكان أحد أبرز عناصر القص في جميع أنواع السرود وفي مقدمتها القصة القصيرة، وربما من الصعب على أي نص قصصي مهما بالغ في حداثته أو ما بعد حداثته أن يستغني عن المكان بوصفه عموداً مهما من أعمدة التشكيل القصصي، وتتنوع أشكال المكان وأنماطه وتشكيلاته بتنوع المنهج القصصي والأسلوب القصصي والقضية القصصية عند كل قاص، حتى لدى القاص الواحد تتنوع فكرة المكان ورؤيته بين مرحلة وأخرى لأنه عنصر يتغير مفهومه بين فضاء وآخر، من خلال قوة الحضور المكاني أو ضعفه بين قصة وأخرى.
حين نبحث في المكان القصصي في القصص القصيرة علينا أن ((نقف على الصور الطوبوغرافية للمكان والتي تخبرنا عن المظهر الخارجي))(1)، وهو ما يساعدنا كثيرا في فهم فضاء المكان الخارجي أولاً، و ((يرسم صورة بصرية تجعل المكان بواسطة اللغة ممكناً))(2)، ومن ثم نستعين بالوصف الذي ((يقدم الأشياء للعين في صورة أمينة تحرص على نقل المنظور الخارجي أدق النقل))(3)، لأنه من دون ذلك ليس بوسعنا فهم الحساسية المكانية للمكان القصصي في أي خطاب سردي يعنى كثيراً بالمكان.
وعلى هذا الأساس يمكننا النظر إلى المكان بوصفه ((نتاج مجموعة من الأساليب اللغوية المختلفة والمختلقة في النص))(4)، التي يمكن من خلالها بلوغ طبقات النص وتلقي عناصره الأخرى على نحو أسهل وأشمل بحيث يلعب المكان في هذه الصورة ((دور المفجر لطاقات المبدع))(5)، ويتجاوز ذلك كي ((يعبر عن مقاصد المؤلف))(6) بطريقة عميقة من خلال الحضور الأصيل للراوي والشخصية، ومن خلال جدل الحضور والغياب المكاني في الخطاب القصصي بما يلاءم مع الموضوع القصصي والمقولة القصصية في جوهر القصة.
تقدم المجموعة القصصية للقاص العراقي نوري بطرس الموسومة بـ (العنكاوي الطائر وهموم النورس الفضي)(7) صورة متجانسة للمكان في معظم قصصها، لكننا سننتخب قصة (نافذة في المنزل) ميدانا لمقاربتنا النقدية للكشف عن حساسية الحضور المكاني الغزير فيها، وهي نموذج مثالي لقوة الزخم المكاني وتجلياته في هذه القصص، والعنوان القصصي عنوان مكاني بامتياز من خلال هيمنة المكان عليه، فمفردة (نافذة) تعبر عن صورة مكان معلّق يحقق نظرا مزدوجا، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، ومفردة (المنزل) تمثل المكان الحاول للفمردة المكانية الأولى (نافذة)، وقد جاءت (نافذة) نكرة، وجاءت مفردة (المنزل) معرفة، أما الحرف الفاصل بين المفردتين (في) فهو ذو دلالة مكانية على طبيعة التلاحم المكاني بين المكانين، حيث إن المكان الصغير (نافذة) يكتسب حضوره وتعريفه من خلال تواجده في فضاء المكان الكبير المرتبط به (المنزل)، بطريقة تجعل المكانين مكانا واحدا في الدلالة على الحضور والظهور اللافت لنظر الراوي والواصف.
إشكالية الحضور والغياب المكاني تظهر منذ عتبة استهلال القصة بطريقة تبدو مفاجئة بعض الشي، إذ سرعان ما ينفتح المكان السردي في القصة على صورة تاريخية للمكان الراهن، ما يلبث أن ينقلب بقوة نحو مسار يضع شخصية الراوي وكل الشخصيات المرتاصفة معه في حيرة كبيرة، بطريقة دراماتيكية ماساوية تنذر بالكثير من الأحداث القادمة:” نافذة قديمة في مدينة موغلة في عمق التاريخ، ما زالت تفوح رائحتها في سفوح المنحدرات وفي ظلال الأشجار والبيوت المتراصفة هنا وهناك، تنظر إلى عيون أهلها وتقرأ فيها ما خبأه التاريخ النائم على آلاف الحوادث، مدينة فوق الروابي العالية تحفّ بها الجبال والغابات.. لكنّ وداعتها انقلبت على حين غرة، تغيّرت عميقاً في لونها وناسها وجدرانها وغدت كأنّها آيله للسقوط، بات كلّ شيء جميل وهادىء فيها طيّ الماضي.. ماذا نفعل يا تُرى بعد هذا الانقلاب المفاجىء في الأشياء، مدينة أخرى ليست مدينتنا التي نعرف، هل نغادرها أم نبقى فيها أسرى الذاكرة”؟
تبدأ القصة بالمكان الصغير المعلّق (نافذة) مع صفتها الدالة (قديمة)، والصفة تأخذ مداها ومعناها من فضاء القدم المرسوم في جملة (في مدينة موغلة في عمق التاريخ)، حيث تتكون سلسلة مكانية متصاعدة في قيمتها السردية (نافذة/منزل/مدينة/تاريخ)، وتبرز الطبيعة بأشكالها المختلفة كي تعطي المكان معناه وتشير إلى جذوته في قوة الحضور، لكن عتبة الاستهلال القصصي تقدم انقلابا سرديا في الرؤية المكانية حين تشير إلى غياب الوداعة في المكان وحضور ما يناقضها (لكنّ وداعتها انقلبت على حين غرة، تغيّرت عميقاً في لونها وناسها وجدرانها وغدت كأنّها آيله للسقوط، بات كلّ شيء جميل وهادىء فيها طيّ الماضي..)، فالتعبيرات السالبة (وداعتها انقلبت/تغيّرت عميقاً/غدت كأنّها آيله للسقوط/بات كلّ شيء جميل وهادىء فيها طيّ الماضي) تدل على غياب الحياة وحضور الموت.
تتوجه كاميرا الراوي نحو حيّز مكاني خاصّ من أجل تصويره تصويرا مزدوجا، تصوير الخارج وتصوير الداخل، تصوير المرئي وتصويرالاحتمال:” يلوح في الأفق خطر ما، الجميع يحدّق في بحيرة من الحيرة، تحلّق الغربان على شرفات المنازل منذرةً بحدوث شيء لا تُحمد عقباه، سرت شائعات بين القوم عن مكيدة تحمل الغدر والخيانة في الطريق إليهم، موت قادم لا محالة يتجلّى في سماء الاحتمال”.
إذ تتمظهر (شرفات المنازل) وقد تحولت من صيغتها المفردة في عتبة العنوان إلى صيغة جمعية هنا من أجل تكبير الصورة وتفعيل المعطى السردي أكثر في القصة، والصورة السردية تحمل في جوهرها الكلامي قصة قصية جداً كاملة (الجميع يحدّق في بحيرة من الحيرة، تحلّق الغربان على شرفات المنازل منذرةً بحدوث شيء لا تُحمد عقباه)، حيث تتجسد كل عناصر التشكيل القصصي القصير جدا في هذه الجملة السردية المتكاملة، وهي تؤسس لنوع من الحضور الاحتمالي الغيبي الذي يقوم على الحدس والتأويل وقراءة الآتي بناء على معطيات الراهن والمرئي المكاني، وهو ما يضاعف من قيمة التداخل بين الغياب والحضور.
يتجلى المكان بعد ذلك في صور مكانية معروفة وتاريخية وأسطورية تشتغل سرديا على تمثيل فضاء الحضور والغياب على نحو جدلي مشتبك:”حلم قديم راود هواجس الكثيرين وضاعف من همومهم، مياه دجلة الصافية ما زالت آتية من النبع القديم في حكاري، حكاية عتيقة من زمن آشور حيث كانت العربات الآشورية الشهيرة تجوب المكان، والعاصمة القديمة ليست بعيدة من هنا أيّها الرجال، ترانيم البيت الأصيل تنوح بأصواته للارض والمياه والعشب الاخضر كما هي منذ القدم”.
فاسم المدينة الظاهر هنا في التعبير السردي (حكاري) يدل على مدينة في الشرق الكردي تقطنها غالبية كردية، أما صورة (العربات الآشورية الشهيرة تجوب المكان)، وصورة (العاصمة القديمة)، وصورة (البيت الأصيل)، تحتشد كلها في سياق سردي مكاني واحد يعبر عن الراهن المكاني، والحلم المكاني، الحاضر المكاني والغائب المكاني، وهذه الصورة المكانية ليست سوى (حلم قديم راود هواجس الكثيرين) فكان يشكل جوهر همومهم التي تحولت إلى (حكاية عتيقة)، والحكاية العتيقة غائبة وحاضرة في المكان والزمن والرؤية.
تستدعي القصة خيوط الحكاية من فضاء التاريخ كي تستوحي المكان مشبعا بالزمن، والزمن مشبعا بالمكان، وكي يتداخل الحاضر بالغائب في لعبة سردية كثيفة، وهذا الاستدعاء لا يتوقف عند حود الحكي والقص والسرد الحكائي بل يتعدى ذلك إلى تمثيل الرؤية السردية:”هنا كانوا أجدادنا وكانت الرحلة طويلة وشاقة، محفوفة بالمخاطر والموت القادم في طيات الزمن الغادر، رحلة يقطعها الرجال بعد ان داهمهم الموت وهم قابعون في بيوتهم، هيا ارحلوا من أرضكم، عساكر من الجندرمة دخلت المدينة وأبادت سكانها، وهرب الكثيرون من دون مأوى، ضباب أسود يلفّ المكان”.
الحساسية السردية المهيمنة على السرد القصصي في القصة يستحضر الأمكنة بطريقة واضحة وعميقة وانشطارية، إن الجملة الماضوية (هنا كانوا أجدادنا وكانت الرحلة طويلة وشاقة) تمزج المكان بالزمن بطريقة عميقة، تستحضر المكان الغائب لترويه بأسلوب حكائي دال، حين يتحول المكان الأليف إلى مكان طارد حتى يصبح الحاضر فيه غائباً (رحلة يقطعها الرجال بعد ان داهمهم الموت وهم قابعون في بيوتهم، هيا ارحلوا من أرضكم)، فالمفردات المكانية المؤلفة للجملة السردية هنا (رحلة/قابعون في بيوتهم/ارحلوا عن أرضكم) هي دوال سردية تنتقل من الحضور إلى الغياب بفعل قوة خارجية ضاغطة (عساكر من الجندرمة دخلت المدينة وأبادت سكانها، وهرب الكثيرون من دون مأوى)، إذ عندما يصبح المكان مهددا بفعل قوة الموت الحاضرة يكون الرحيل وغياب المكان معادلا لحضور الإنسان وحياته.
إن فكرة الرحلة والرحيل وترك الأرض والوطن والبيت والنافذة تحكي قصة النزوح من أجل البحث عن ملاذ حاضر في ظل غياب قسري للمكان الأصل، وتتحول التجربة القاسية للشخصيات إلى تجربة يختلط فيها الحياة بالموت:” إنّها الحرب قادمة على الفقراء، نَزحَ الحكاريون من ديارهم باتجاه الحدود الآمنة، تركوا الديار والأبواب مفتوحة ومشرعة للجندرمة، لم يبق غير نقطة مضيئة صغيرة تلوح من بعيد كشعاعٍ مضيءٍ في ليل بهيم، الجموع تسير نحو مصيرها المجهول عبر المخاض العسير والأسلاك الشائكة والطريق الموحلة، قافلة طويلة تعلوها التراب والغبار والدخان اللزج الكثيف”.
فجملة (الحرب قادمة على الفقراء) هي جملة عميقة الدلالة في اقتصار صورة الحرب المقترنة بالموت على الفقراء فحسب، على نحو يجعل الحياة مكانا للأغنياء، والموت مكانا للفقراء، بحيث تأتي جملة (تركوا الديار والأبواب مفتوحة ومشرعة للجندرمة) لتعبر عن جدل الحضور والغياب المكاني في السرد القصصي، وتتكشف الرؤية المكانية عن مكان سائر مصحوب بالموت الكامن في أية لحظة، وهذا المكان السائر غير المستقر هو (قافلة طويلة تعلوها التراب والغبار والدخان اللزج الكثيف)، ويتمظهر بوصفه مكانا لا ثبات له مشحون بالاحتمالات السلبية التي تتموكز دائما في مجال الموت والغياب لا الحياة والحضور.
إن البحث عن مسار للحياة والحضور الموصوف بالأمن وحلم الاستقرار والمكوث الطويل في المكان الحقيقي، هو المسار المبتغى الذي تبحث عن الشخصية القصصية الراوية ومن خلفها الشخصيات الأخرى المرتبطة بها، في ظل فضاء الحيرة والخوف والرعب الذي يحاصر ذوات الشخصيات ويغمرها في الغياب:” من يدلنا على طريق آمن في هذه الفاجعة، ليس ثمّة نجم في سماء المشرق يرشدنا إلى طريق، تتشابك الطرق الملتوية وتنحدر نحو أسفل الوديان، سرعان ما تعلو وتغدو عالية شاهقة وكأنّها معلقة في الفضاء، ومن بعيد تطلّ على سهول نينوى الممتدة لمسافات طويلة، لاحت لعين الناظر والجموع تواصل المسير في رحلتها الجهنمية وكأنّها في نفق طويل مظلم، كانت وما تزال تحلم بالوصول إلى أرض الأجداد”.
يظهر المكان الطبيعي (الوديان والسهول) بوصفه مكاناً معادياً مرتبطاً بتجربة الموت أكثر من ارتباطها بتجربة الحياة، فالسؤال المصيري (من يدلنا على طريق آمن في هذه الفاجعة) هو سؤال إشكالية الحضور والغياب المكاني في فضاء القصّ، وربما تبرز مكانية محددة ذات تأثير عميق على مستوى التاريخ والرهان هي (سهول نينوى الممتدة لمسافات طويلة)، كي تحيل على رؤية قصصية معينة لها علاقة بهوية الخطاب.إن هذه القصة تنتقل في نظم صوغها المكانية من أصغر وحدة مكانية مرئية ومألوفة إلى أوسع وحدة مكانية تمتد في عمق التاريخ، وهو ما يجعل من حضور فكرة الدفاع عن الهوية داخل الخطاب القصصي فكرة أساسية وجوهرية لا تكتفي بالموضوع بشكله المجرد، بل تنطوي على آفاق دلالية لها علاقة بتوكيد الهوية وحضورها في المكان والزمان على نحو أصيل، وعنصر المكان هو العنصر الأول والأبرز في صراع الحضور للعناصر الأخرى.ويؤدي المكان دورا بالغ الأهمية والخطورة في اللعب على قوة حضور عناصر القص الأخرى بشكل شاسع وعميق وأصيل، على نحو يجعلنا ننظر إلى قصص ((هموم النورس الفضي)) في تجانسها وتآلفها وتشابهها بوصفها قصة واحدة تتعدد في صياغاتها، فالشخصية تقريبا واحدة في ظل أمكنة واحدة تتوع في صياغاتها وحساسياتها ومقولاتها.
الإحالات والهوامش:
(1) بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، حسن بحراوي، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط1، 1990: 60.
(2) بناء المكان، سمر روحي الفيصل، مجلة الموقف الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 306، 1969: 13.
(3) بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، سيزا قاسم، الهيثة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984: 80.
(4) استراتيجية المكان، مصطفى الضبع، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1998: 151.
(5) استراتيجية المكان: 70.
(6) بنية الشكل الروائي: 32.
(7) العنكاوي الطائر وهموم النورس الفضي، نوري بطرس، منشورات ضفاف، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، ط1، 2015
رابط المقال في جريدة الاتحاد: ص 7
http://www.alitthad.com/20102015/
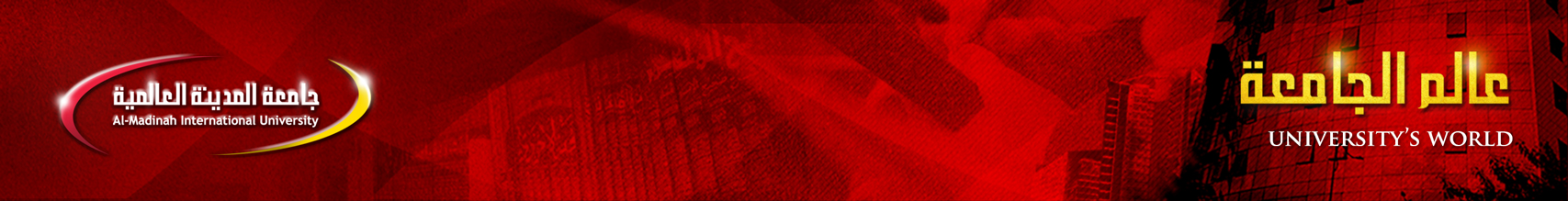 MEDIU World جامعة المدينة العالمية مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية، ومقرها ماليزيا وهي مرخصة من وزارة التعليم العالي الماليزية، البرامج معتدمة من هيئة الاعتمادات الماليزية.
MEDIU World جامعة المدينة العالمية مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية، ومقرها ماليزيا وهي مرخصة من وزارة التعليم العالي الماليزية، البرامج معتدمة من هيئة الاعتمادات الماليزية.